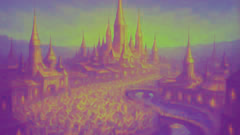المقدمة
كانت مدينة أوملاس مشهورة بأبراجها الذهبية الشاهقة التي تعانق السماء اللازوردية، مكان تمتزج فيه ضحكات الأطفال والموسيقى لتنسج سجادة من الاحتفال والسلام الدائمين. كل عام، كان مهرجان الأنوار يضيء قنوات المدينة وشوارعها بفوانيس صنعتها أيادٍ مفعمة بالفرح، ويشعر المواطنون بقلوبٍ تتسع بفخرٍ جماعي. كان التجار يحيّون بعضهم بعضًا بحرارة بينما ترفرف الأعلام على طول الممرات المرصوفة بالحصى، وكان الشعراء يرددون أبياتًا تتحدث عن عالم خالٍ من الحاجة. ومع ذلك، تحت هذا الابتهاج الساطع كان هناك تفاهم ضمني: وئام أوملاس قائم على حقيقة منفردة، مظلمة ومخفية. بأصواتٍ هادئة علّم الشيوخ الجيل الأصغر أن الازدهار ليس هبةً بل اختيارًا—اختيار يحمل عبئًا لا مفر منه. لم يتحدث أحد عن الثمن جهارًا في العلن؛ كان يكفي أن يحمل كل نفس هذه المعرفة سرًا، شوكة في العقل تخنق كل لحظةٍ من الفرح غير المشروط. تقبل معظم الناس هذا الثقل الصامت، مؤمنين أنه التوازن الضروري للنعيم. قليلون، غير قادرين على تحمل التكلفة، تلاشتهم الليالي. ساروا نحو آفاق بعيدة، حيث يتلوى الطريق إلى المجهول، لا يَهديهم سوى ضميرٍ وحنين إلى سلامٍ أكثر صدقًا.
تحت الأبراج الذهبية
ارتفعت أوملاس من تلالٍ ناعمة إلى سهلٍ واسع حيث تفرعت الأنهار كشرائطٍ فضية. ربطت قناطر رائعة وممرات مقببة أبراجًا من الحجر الشاحب، منحوتةً عليها نقوش الفرح والوفرة. تحرك المواطنون بتناغمٍ يسير، وكانت خطواتهم تتردد كموسيقى عبر الأروقة المعلّقة بالأكاليل العطرة. ارتفعت الضحكات في ساحاتٍ بعيدة بينما يطارد الأطفال فراشاتٍ مرسومة بضوءٍ نابضٍ بالحياة. اجتمع العلماء في منتدياتٍ مفتوحة لمناقشة طبيعة اللطف وشكل الطوباويات المستقبلية، وزيّن الفنانون النوافير العامة بفسيفساء تُصوّر الروح البشرية في أبهى حالات الابتهاج. نزل الليل كستارة مخملية مخترقةً بتوهج الفوانيس؛ لم تنم المدينة حقًا، فقد حافظت دهشتها الجماعية على نبضها. حتى في الساعات الهادئة، كان همسٌ من الرضا ينساب عبر الشوارع الخالية، تحمله نسائم باردة تفوح منها رائحة الياسمين والوعد.

ومع ذلك، لم يلمع كل ركنٍ في أوملاس بفرحٍ مشترك. تحت الساحات الرخامية كانت تكمن حجراتٌ خفية حيث يُحفظ سر المدينة. باب واحد مقفول، لا يلفت انتباه معظم العيون، قاد إلى سجلات حجرية تنزل إلى قبو فسيح. هنا، في ظلمةٍ دائمة، انتظر طفلٌ وحيد. كان الهواء في هذا المكان ثقيلاً وراكدًا، وتحمل الجدران بقع رطوبة من تسريباتٍ طالها النسيان. تحرك الحراس المتمركزون أعلاه بصمتٍ، وقلوبهم مثقلة بالواجب والحزن. قلما تحدثوا عما يكمن أدناه، ولكن كل واحدٍ منهم كان يعلم الحقيقة الأساسية: لا تستطيع أوملاس أن تبقى في بهائها إلا إذا قُدّمت حياةٌ واحدة مقابل عددٍ لا يُحصى من الأرواح. فهم كل المواطنين للعهد كان واضحًا، ورأى الجميع الطفل مرة أو أكثر—مع أن قلةً فقط استطاعت لقاء بصره دون ارتعاش. تداخل الاحترام مع الاشمئزاز وهم يديرون وجوههم بعيدًا، واضعين أيديهم على أفواههم لكتم أي صيحة احتجاج.
أحيانًا كانت همسات الشك تشتعل بين الشبان المستعدين للانضمام إلى صفوف المدينة. تساءلوا ما إذا كانت سعادةٌ مبنية على المعاناة قادرةً على الاستمرار، وما إذا كان بريق أوملاس ذاته مجرد وهم هش. اندلعت المناقشات في لقاءات سرية، أصواتٌ مكتومة لكنها ملحة. جادل بعضهم بأن تضحية الطفل هي الجذر المظلم الذي نبتت منه كل جمال، حقيقة لا مفر منها في الوجود البشري. وأصر آخرون أن التقدم الحقيقي يتطلب رحمة بلا قسوة، وأن المجتمع لا ينبغي أن يجيز مثل هذا المقايضة. لم ينتصر أي طرف؛ ظل الإجماع المتوجس قائمًا، واستمرت التحضيرات للمهرجان. كان المشاهدون في الشرفات أعلاهم يرفعون نخبًا لمؤسسي المدينة، غير مدركين للروح المسجونة تحت أقدامهم.
مع اقتراب الفجر مرةً أخرى، تسرب نورٌ ذهبي عبر شقوق الأرضية أعلاه، مضيئًا ملامح الطفل الشاحبة. كان شعره المبتل يلتصق بجبينه، ولامست عيناه الواسعتان، المتلهفتان للحرية، شعاع الضوء. في تلك اللحظة بدا قلب أوملاس وكأنه يومض بين النور والظل، توازنٌ هش يعتمد على نفسٍ واحد.
الطفل المخفي
في الصمت الذي يسبق مهرجان المرايا، عندما تكون الشوارع خاوية ولا تلقي سوى الفوانيس توهجاتٍ منتظرة، يتم إرشاد قلةٍ مختارةٍ إلى تحت الأرض. يرافقهم مسؤولون عبر أبوابٍ بلا علامات، ويصدح كل قفل حديدي كقرع أجراس الموت. يتجمعون حول الزنزانة، صامتين ومهيبين. يجلس الطفل، الذي لا يزيد عمره عن سبع أو ثماني سنوات، على بطانيةٍ مهترئة الحواف. كانت أضلاعه تظهر بخفة تحت جلده الرقيق، وعيناه تلاحقان كل حركة بمزيجٍ من الخوف والفضول. يصرف الزوار أبصارهم، وتتلألأ الدموع في زوايا العيون بينما يثقل على كل قلب عبء التواطؤ.

نطق صوت رقيق—فيلسوف أوكلت إليه الرعاية—متكلمًا ليذكّرهم بالضرورة. «هذه التضحية تُبقينا. بدونها ستنهار الأبراج، وتجف الأنهار، ويحل العذاب بكل نفس.» بدا الكلام محفوظًا عن ظهر قلب، لكن حتى صوت المتكلم انكسر عند العبارة الأخيرة. واحدًا تلو الآخر وضع الزوار قرابين من طعامٍ وقطع قماش ناعمة، معبرين عن امتنانٍ كاد أن يخنقهم. امتد الطفل ليأخذ رغيف خبزٍ طازج، وكسر صيامه بصمت.
بين الحاضرين كانت هناك معلمة شابة علمت أطفال المدينة القراءة ذات يوم—علمتهم أن يروا الجمال في الكلمات. لكن الآن كان الذنب يلتف في عروقها كالثلج. تذكرت الفصول المضيئة والعقول المتفتحة، وتساءلت إن كان يمكن للرحمة أن تزهر بدل الخوف. ارتجفت وهي تدرك أنها لن تتكلم. بدلاً من ذلك ابتعدت، وترددت خطواتها بغرابة في الممر. لاحظ الآخرون ذلك وقلوبهم تخفق. تبعها قلة—مختارون الضمير على الراحة—مغادرين إلى الظلام الجذري وراء البوابات المقفلة.
خلفهم أغلق الفيلسوف الغطاء، مختومًا عالم الطفل بالظل. تراجعت الأصوات، فلم يتبقَّ سوى تقطير الماء وهمهمة المدينة أعلاه. اكتملت التضحية لسنةٍ أخرى، وتجدّد العهد مرةً أخرى.
خيار الرحيل
في ليلة الاحتفال امتلأت شوارع أوملاس بزوارٍ من بلداتٍ بعيدة، جذبتهم قصص الفرح الفريد. تمايلت الفوانيس كموجاتٍ بينما رقص السكان والضيوف حول نوافيرٍ تنفث ألوانًا ضوئية. ملأت الموسيقى الهواء—آلات وترية، ومزامير، وأصوات متشابكة في ألحانٍ تتغنى بالحرية والوحدة. امتزج عبق المعجنات السكرية مع رائحة الزهور التي تتفتح ليلًا، وكانت الوجوه تتألق بالتوقع. هنا بدا أن الحياة خاليةٌ من الأثقال، انعكاسٌ نقي للأمل المتحقق.

ومع ذلك، عند طرف الاحتفال امتد طريق ضيق إلى ما وراء وهج الفوانيس إلى غاباتٍ معتمة وتلالٍ غير معروفة. انسلَّ أولئك القلائل الذين عرفوا سر المدينة عبر ذلك المسار. كانت خطواتهم صامتة في البداية، وقلوبهم مثقلة بالحزن والعزم. حمل كل منهم ما يحتاجه فقط: ملابسٍ للبدل، رغيف خبزٍ صغير، وعبء خياره. لم يتحدثوا عن الرجوع؛ فذلك كان يعد خيانةً لضميرٍ أيقظوه حديثًا.
بينما واصلوا السير تحت بلوطاتٍ عتيقة، خفتت الأصوات حتى لم يبقَ سوى أنفاسهم وهمس الأوراق. لامس بعضهم ارتعاش الخوف—ماذا سيحمل العالم هناك؟ لم تكن هناك شوارع مضاءة بفوانيسٍ ولا نوافير، ولا سعادة مضمونة. كان هناك احتمال واحد: عالم لم تشكله خطايا خفية، عالم قد تأتي فيه البهجة بلا ثمنٍ سوى العمل الجاد والرحمة.
وراءهم كانت أوملاس تنبض بالنور والضحك. أمامهم كانت النجوم تتلألأ بصفاءٍ بارد. التفت قلة مرةً واحدة، ناظرةً إلى المدينة التي ربّتهم رغم مطالبتها بالمستحيل. ثم، بخطى ثابتة، ابتعدوا.
الخاتمة
في الأيام التالية انتشرت حكايات أوملاس بعيدًا وراء حدودها: مدينةٌ من الجمال والاحتفال، لكن مربوطة إلى الأبد بمعاناةٍ خفيّة. الذين بقوا طمأنوا أنفسهم بأنهم أذكى لأنهم قبلوا المقايضة، مؤمنين أن الفرح الحقيقي لا يأتي بدون تضحية. حمل الذين رحلوا قصةً مختلفة—قصة وضوحٍ أخلاقي وسعيٍ نحو نوعٍ جديد من السعادة. سواء صمدت أوملاس أو انهارت، فإن إرثها يطرح على كل مسافر سؤالًا عن الثمن الذي هو على استعدادٍ لدفعه لقاء السلام. سيختار بعضهم نعيمًا مخففًا بالذنب، ويختار آخرون دربَ النزاهة غير المؤكَّد. وفي كل قلب يبقى السؤال معلقًا: هل يمكننا بناء الكمال بلا ظل؟