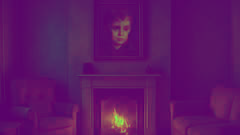المقدمة
قليلة هي الأساطير الحديثة التي أسرَت خيال المجتمع البريطاني كما فعلت حكاية لوحة "الصبي الباكي". إنها قصة تُهمَس بها أثناء الشاي، وتُناقَش في المنتديات الإلكترونية، وتُروى عبر أجيال يَحلف أصحابها بأنهم لمحوا تلك العيون المسكونة بأنفسهم. بالنسبة للبعض، هي مجرد طبعة قديمة — واحدة من آلاف النسخ التي أُنتجت بكميات هائلة في أوروبا بعد الحرب، وكانت تزيّن جدران الشقق السكنية والمنازل شبه المنفصلة من شرق لندن إلى الشرفات المعرضة للرياح في يوركشاير. بالنسبة لآخرين، فهي نذير كارثة: تحفة ملعونة تختبئ خلف ورق حائط مزهّر، تُحمّل نظرة الطفل الملطخة بالدموع مسؤولية الحرائق والدمار. على مرّ السنين، أجّجت عناوين الصحف أسطورة اللوحة. يتبادل رجال الإطفاء قصصًا عن منازل التهمتها حرائق مفاجئة، حيث بدا كل شيء رمادًا ما عدا لوحة واحدة — بقيت سليمة كما لو أن قوة ما حمتها. يقدّم المشككون تفسيرات منطقية، مستشهدين بتصنيع رخيص وخرافات حضرية، لكن من شهدوا نظرة اللوحة الثابتة نادرًا ما يجدون عزاءً في المنطق. بالنسبة للعائلات التي فقدت منازلها وذكرياتها، وللجامعين الذين يجرؤون على تعليق اللوحة متحدين، وللباحثين عن كشف لغزها، فإن لوحة الصبي الباكي أكثر من مجرد طلاء على ورق. إنها حكاية أشباح بريطانية معاصرة — مزيج من الفن والمأساة والرهبة المستمرة من المجهول.
الأصول: من الاستوديو إلى غرفة الجلوس
لم تبدأ أسطورة لوحة الصبي الباكي في رماد منزل محترق، بل في استوديوهات إسبانيا الصاخبة في خمسينيات القرن الماضي. كانت اللوحة الأصلية — إحدى عشرات النسخ — من عمل فنان إيطالي قليل الشهرة كان يوقع أعماله باسم "براغولين". الفنان، واسمه الحقيقي برونو أماديو، كان يتخصص في بورتريهات الأطفال الباكين: عيون كبيرة، وشفاه مرتجفة، وخدود مبللة بالدموع. كانت شخصياته تهدف إلى استثارة التعاطف والكآبة، وربما تقديم تحذير من الإهمال. ومع انتشار الصور عبر أوروبا، أخذ طابعها يصبح أكثر قتامة وإثارة للقلق.

بحلول ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، رأى المستوردون البريطانيون فرصة. بدأت نسخ رخيصة من لوحة الصبي الباكي، ورفيقتيها — الفتاة الباكية والطفل الباكي — في الظهور في محلات السوق الرئيسية وكتالوجات الطلب بالبريد. كانت الطبعات ميسورة التكلفة ومنتَجة بكميات كبيرة، ووصلت إلى آلاف المنازل. كان في عيون الأطفال الحزينة نوع من العزاء الغريب؛ شعور بأن حزنهم قد يمتص مصائب الأسرة بطريقة ما. بالنسبة للعديد من الأسر العاملة، كانت هذه اللوحات شائعة مثل ستائر الدانتيل أو طيور الزينة المعلقة على الحائط.
لكن بينما تكاثرت الصور في غرف المعيشة، تلاشى الفنان نفسه في طي النسيان. ظل برونو أماديو لغزًا: قيل إنه رسم الأطفال بعد أن شاهد دمار الحرب؛ وهمس آخرون بأن نماذج لوحاته كانوا أيتامًا لقوا مصائر مأساوية. زاد هذا الغموض من هالة اللوحة. لم يستطع أحد تحديد أصولها بدقة، ومع ذلك كان معظم الناس يعرفون شخصًا واحدًا على الأقل يمتلك نسخة معلقة في منزله.
مرت عقود. كبر الأطفال ورحلوا، وتركت اللوحات لتتراكم عليها الغبار في صالونات الأجداد أو في محلات السلع المستعملة. لفترة بدا أن لوحة الصبي الباكي قد تظل مجرد بقايا ديكور ما بعد الحرب — حتى تدخل القدر، أو شيء أظلم، وغير ذلك.
سنوات إشعال الحرائق: ذعر الصحف ومخاوف فرق الإطفاء
بدأ التحول من طبعة عاطفية إلى شيء ملعون فجأة. في عام 1985، نشرت الصحيفة الشعبية البريطانية "ذا صن" تقريرًا على الصفحة الأولى بعنوان سرعان ما انتشر صداه في أنحاء البلاد: "لعنة الصبي الباكي المشتعلة!" ذكر التقرير سلسلة من الحرائق الغامضة في يوركشاير وما وراءها، وكانت القاسم المشترك فيها نسخ من لوحة الصبي الباكي معلقة على الجدران. والأكثر رعبًا أن التقارير ادعت أنه بينما تحول كل شيء آخر إلى حطام أسود محترق، بقيت اللوحة سليمة دون مساس.

سرعان ما امتلأت خطوط هواتف محطات الإطفاء المحلية بمكالمات القلق. روى الناس قصصًا مروعة عن حرائق ليلية: فرقعة مخيفة، ودخان خانق، وبعد ذلك الاكتشاف الغريب للوحة وهي موجهة بوجهها نحو الأعلى وسط الرماد. حلف بعضهم أنهم حاولوا إحراق اللوحة بأنفسهم، لكنهم شاهدوا أنها خرجت من بين اللهب كما لو أنها محمية بدرع غير مرئي. وآخرون، يائسون للتخلص من اللعنة، رموا نسخهم في مكبات النفايات أو أحرقوها في الحدائق الخلفية — ومع ذلك استمرت القصص التي تقول إن الصورة كانت تعاود الظهور في المنزل، أو أن مصيبة تصيبهم بعد إزالتها بفترة قصيرة.
لم تكل الصحف الصفراء من تغطية الأمر. خلال الأشهر التالية تكاثرت القصص. تحدث تقرير واحد عن عائلة فقدت ثلاثة منازل في حرائق، وفي كل مرة كان ذلك بعد تعليق نسخة مختلفة من لوحة الصبي الباكي. ادعى زوجان مسنان في روثرهام أن شقتهما احترقت بالكامل خلال أيام من استلامهما الطبعة كهدية. وصفت امرأة من ليفربول كيف حاولت تدمير اللوحة فإذا بمطبخها يحترق في اليوم التالي. في الشمال، بدأ رجال الإطفاء يتبادلون قصص "اللعنة" في غرفة الاستراحة. بعضهم رفض حتى دخول منازل تعرض فيها اللوحة، متذرعين بأنهم رأوا كثيرًا من الناجين الذين كانت لوحتهم الحزينة الشيء الوحيد السليم وسط الدمار.
وسط هذا الذعر، قدم الخبراء تفسيرات أكثر اعتيادية. أشار الكيميائيون إلى أن ورنيش الطبعة كان مقاومًا للاشتعال بدرجة كبيرة، مما يجعلها أقل احتمالًا للاحتراق مقارنة بورق الجدران أو الأثاث القابل للاشتعال. لكن بالنسبة لأولئك الذين تقلبت حياتهم رأسًا على عقب، لم تقدم المنطق العلمي عزاءً يذكر. اشتعلت الأسطورة في خيال الجمهور، وسرعان ما صارت اللوحة أقل زينة منزلية وأكثر نذيرًا — رمزًا ليد القدر القاسية، معلقة في زاوية كل غرفة جلوس سيئة الحظ.
انتشار اللعنة: العائلات والخوف والتحدي
بحلول أواخر الثمانينيات، اجتاح الخوف مجتمعات بريطانيا بأسرها. كان مستأجرو السكن الاجتماعي ينقلون التحذيرات من شقة إلى أخرى: تخلص من اللوحة أو خاطِر بالكارثة. امتلأت متاجر السلع المستعملة وصناديق التبرعات بطبعات مهملة، ووجوهها الملطخة بالدموع تطل من خلف روايات رومانسية باهتة وأطباق مشروخة. نظمت بعض البلدات حتى احتفالات حرق جماعية، حيث اجتمع الجيران في الحدائق المحلية لحرق أكوام من طبعات الصبي الباكي في نيران ضخمة. ومع ذلك، دار الغموض بأن اللعنة بقيت قائمة — وربما اشتدت بفعل محاولات التدمير.

داخل العائلات اندلعت مشاحنات. تشبث الأقارب المسنون بلوحاتهم، مصرّين على أنها لا تؤذي، بينما طالبت الأجيال الشابة بإزالتها. أخذت الأسطورة منحنيات جديدة مع تعقيد الحكايات: أم تطاردها أحلام يهمس فيها نحيب الصبي الصامت، تلميذ يظن أن مرض حيوانه المفاجئ مرتبط باللوحة، وفتاة مراهقة تدّعي أن الصورة تحرّكت عندما لم تكن تنظر. في الحانات ومحطات الحافلات، تبادل الناس القصص — بعضها مأساوي، وبعضها طريف، كلها مشبعة بفضول متوتر.
وفي الوقت نفسه نشأت حركة مضادة. بدأ قلة من المتشككين — من جامعي الأعمال الفنية والصحفيين وطلاب الجامعة — يبحثون عن اللوحة عمدًا. علّقوها بفخر في منازلهم، داعين الأصدقاء ليشهدوا تحديهم. سخر بعضهم من اللعنة متحديًا إياها أن تفعل أسوأ ما عندها. وحاول قلة تنظيم معارض، وضعوا عشرات الطبعات معًا في غرفة واحدة على أمل تحييد الخرافة بالجرأة. لكن هذه الأفعال نادرًا ما اهتزّت سمعة اللوحة. بل إن كل حادث حريق يُبلغ عنه قرب أحد بيوتهم بدا وكأنه يعزز الأسطورة: حتى لو كانت مجرد صدفة، صار من الصعب تجاهلها بعد استقرار الخوف.
مع مرور السنين وتلاشي التغطية الإخبارية، بقيت شهرة اللوحة باقية على هامش الثقافة البريطانية. أصبحت لوحة الصبي الباكي عنصرًا راسخًا في الفولكلور الحضري، جنبًا إلى جنب مع حكايات الكلب الأسود "بلاك شوك" والركاب الشبح. في بعض البلدات، لا يزال العثور على نسخة قديمة في سوق للسلع المستعملة يثير ضحكات متوترة أو نظرات جانبية. لقد نسجت اللعنة نفسها في نسيج الحياة اليومية، فأصبح من المستحيل تبديدها بالحقائق أو بالتفاخر وحده.
الخاتمة
حتى الآن، وبعد عقود على أول إدانة علنية لها، ترفض أسطورة لوحة الصبي الباكي أن تتلاشى. في أسواق السلع المستعملة ومحلات التحف في أنحاء المملكة المتحدة، لا يزال الوجه الحزين يطل من خلف أكوام البضائع المتنوعة. يشتريه البعض كقطعة لفتح الحديث؛ يشتريه آخرون كمزحة أو لاختبار القدر. لكن الكثيرين سيعترفون — ولو بهمس — أنهم لن يعلّقوه على حائط منزلهم. في مثل هذه القصص قوة مقلقة: تذكير بأن حتى في عصر العقلانية، تظل الخرافة حيث تغوص العواطف عميقًا. لعنة لوحة الصبي الباكي أقل ما تكون عن الأرواح الشريرة وأكثر عن طرق انتقال الخوف من جار إلى جار، ومن جيل إلى جيل. إنها تعيش في السرد — درس في كيف يمكن للأشياء العادية أن تكتسب معانٍ غير عادية، وكيف تترك المأساة أثرها أحيانًا ليس فقط على البيوت والقلوب، بل على الثقافة نفسها. لا تزال عيون اللوحة تطارد من يتوقف أمام إطارها، مطمسة الخط الفاصل بين الممكن والمستحيل، وبين ما نؤمن به وما نخشاه.