المقدمة
عاليًا فوق الأزقة المرصوفة في لوسيرن، ارتفعت أبراج كنيسة هوفكيرخه التوأمية كجبابرة ساهرين منحوتين في الجرانيت، ظلالها منقوشة على سماء ملطخة بألوان الغسق. داخل تلك الجدران العتيقة، تقول الأسطورة إنه عند دقات منتصف الليل تتحرّك يدٌ غير مرئية مفاتيح الأرغن العاجية، مطلِقةً وصلاتٍ طيفية تلتصق بالروح كندى الصقيع. تسلّلت رائحة الخشب القديم والرزين من كل ماسورة، توقظ ذكريات طويت طويلاً داخل الحجر المملوء بالمونة. كان السكان يخفّون خطواتهم خارج الكنيسة، مشدودين إلى لحنٍ يتحدى براعة البشر، يصيب جوهر اللغز بدقة في نغمةٍ مرتعشة واحدة. تهافت العلماء همسًا عن عهودٍ اختُتمت بضوء الشموع، بينما حذر الشيوخ من أن هنا يكمن السر حين ينساب لحنٌ من الظلام. تنهدت ريح بعيدة عبر الأزقّة الضيقة، حاملةً صدى موكب جنائزي يلامس الأذن كتهويدةٍ شبحيّة. حتى الحراس المتمرّسون ارتجفوا عند مطلع الأرغن، فالموسيقى كانت تحمل أكثر من صوت—كانت تحمِل ثِقَل أرواحٍ غابرة تبتغي المرور. في هذا العالم بين الأرض والأثير، كانت جوقةٌ شبحية تنتظر قائدها على مسرحٍ من جدارياتٍ مضيئة بضوء القمر، كل جداريةٍ وعدٌ جامد بظهوراتٍ مقبلة. كان الأرغن وارثًا لقرونٍ من الأسرار، وكانت كل عزفٍ منتصفي يعيد نسج الحجاب الهش الفاصل بين الأحياء والأموات. تقطّرت النوافذ بقطرات التكاثف كدموعِ حداد، وكانت أرضية الحجر البارد زلقة تحت الأقدام المرتعشة. علقت في الهواء رائحة خفيفة للشحم الذائب كأنها تتوسّل أن تُذكَر. انحنت أنابيب الأرغن كثعابين ملفوفة، تنتظر بصبر نداء منتصف الليل. ذات مرة حلف تلميذ أنه رأى نور الشموع يرقص على الشرفات، رغم أنه لم تُشعل فتيلة واحدة. كانت ليالي لوسيرن تحبس أنفاسها، محتجَزةً في شبكةٍ من صمتٍ متوقّع وخشيةٍ مهيبة.
أصول لحن منتصف الليل
وقتٌ طويل قبل أن تمتدّ لوسيرن عبر نهر الرّويس وتطفو البواخر بمحاذاة الجسور الخشبية، وُضعت أسس كنيسة هوفكيرخه على صخورٍ قديمة استُخرِجت من المنحدرات المحلّية. صانع الأرغن الرئيسي، يوهان شتايجر، رجلٌ متديّن بقدر ما هو عنيد، كدّ لثمانية شتاءات وصيفات ليجمع آلةً قيل إن أنابيبها تحوي شرائحٍ من خشب أشجار «اليو» الألبية، قُطفت كلّ واحدةٍ تحت قمرٍ دموي. فاحت ورشة العمل برائحة الخشب الطازج والرصاص المصهور، عبقٌ لاذع تمسّك بمنضدة الحرفي ويديه، ناسجًا الطموح والهوس معًا. صنع المنفاخات من جلدٍ طريّ وصقّل كل مفتاح حتى لمع كحَدِّ رأس السهم، راغبًا في اختراق قلب العبادة. تردّد السكان همسًا عن رنين أدواتٍ تتناغم في ورشة الغسق، افتتاحية سرية توحي بقدرةٍ تتجاوز إدراك البشر. في حفل الكشف، تلألأت الشموع كأنها مفزوعة ورقصت ألسنتها فوق الأرضيات الفسيفسائية كطيورٍ مذعورة. ذرف المرتادون دموع الفرح، ومع ذلك لم يكن لأحد أن يتصوّر الموسيقى التي ستتنفّس يومًا باستقلاليةٍ شبحيّة. تحت وهج الفوانيس الكهرماني بدت الجدران نفسها كأنها تتنفس، تنضح بالرطوبة التي تبرد الجلد كلمسةٍ شبحية. نُقشت نهايات كل ماسورة بزخارف رونية، كأن شتايجر يتضرع إلى رعاةٍ غير مرئيين طالبًا الهداية. وعندما كُشف الأرغن أخيرًا، دوّت نغمته الأولى بعمقٍ جعل الأرض تحت الكنيسة ترتجف لوهلة، مفزعةً حتى التماثيل الغارغويل القديمة الجاثية في الخارج.
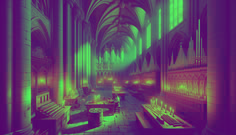
مع تقدم الأرغن في العمر تعمّق صوته، صار رنانًا كهدير جبلٍ يتدحرج عبر قمم الجرانيت. تسجّل دفاتر المدينة لعام 1523 حادثةً غريبة هزّت حتى المشككين. أثناء عاصفة مطريّة، صعدت تلميذة شتايجر، إلسبث، إلى المنبر لتتفقد صمامًا هوائيًا عنيدًا. أبلغت أن مفتاحًا واحدًا انخفض من تلقاء نفسه، مطلقًا زمجرةً منخفضة التفَتت حول كاحليها كسلسلةٍ حية. ارتدت مذعورة، لكن الصوت تلاحقها، يتردّد في القِباب الضلعيّة حتى صمتته غرابته الخاصة. لم يعثر المحققون على أسلاكٍ ولا عازفٍ خفي—بل وجدوا الآلة وحسب، لا تزال دافئةً عند اللمس، تهمهم بصوتٍ باردٍ كثلج الألب عند الفجر. قال البعض إن الأرغن "استيقظ"، موروثًا شظيةً من روح صانعه، شعورٌ يطارد النفس لدرجة أنه بدا يثقب الحجاب بين الحياة والموت مع كل نغمة.
بحلول أواخر القرن السادس عشر جذبت الشائعات فضوليين من أرجاء أوروبا. طالب الأرستقراطيون ورجالُ الدين معًا الحضور في سهرات منتصف ليل مضيئة بالشموع على أمل مشاهدة استقلال الأرغن الغريب. جمع ذلك ثرواتٍ من الرسوم والتبرعات، فكانت القطع الفضية تُلقى في صناديق الصدقات كأنهم يشترون تذكرةً إلى كرنفالٍ من الأشباح. أحيانًا كان العلماء يدونون ملاحظاتهم على ضوء المشاعل المرتعشة، يرسمون خرائطٍ لتلك الوصلات الطيفية كما لو أنهم يرسمون بروجًا سماوية. لكن التسلسلات تحدّت كل نظريات؛ السلالم النغمية التوّلت ككرومٍ أفعوانية وتفتّحت الوصلات كزخاتٍ طيفية من الصوت. بدا جدار الكنيسة الحجري، المنقوش بالقديسين والملائكة الشهيدة، وكأنه يميل للأمام متلهفًا لاستنشاق كل شِبْرٍ من النغم. وعندما سكت الأرغن عند الفجر، عاد السواد بسرعةٍ جعل الذاكرة نفسها تشعر وكأنها مُسلبةٌ من الإحساس.
ومع تزايد الرهبة ظل الأرغن رمزًا لقوّة لوسيرن الروحية، تهمس أسطورته في الحانات المكسوة بخشب البلوط مثل عبق الشراب المعتّق في الكؤوس المتشققة. زعم بعض الشيوخ أن كل نغمة تستدعي روحًا في طريقها إلى الحساب، بينما رأى آخرون أنها لا تعمل سوى صدى للحزن المحتجز داخل الجدران. العلماء الذين تجرّأوا على تدوين موسيقاها نُهشوا إلى دفاتر هيستيرية ونوتات مشفّرة، وخطّهم المائل كجذور أرزٍ معوّجة تبحث عن جداولٍ خفية. وفي لهجات محلية تمتموا "هنا يكمن السر"، شاعِرين أن جوهر اللغز مدفون تحت طبقات الزمن والإيمان. هكذا اندمجت الحِرفة بالأسطورة في أصول الأرغن، فنسجت حكايةً خالدة ستتشابك لاحقًا مع حياة الحراس والمتجوّلين، جميعهم مأخوذون بعناقها الليلي.
عبر أجيالٍ تسرّب حديث الأرغن إلى تهويدات وأهازيج تُغنّى في الحانات المدخنة حيث تومض نيران المواقد كحضورٍ منتبه. كانت القابلات تهدّئ الرضع بأنغامٍ معدلة، غير مدركات عمق الحزن المتشابك في كل لحن. كتابٌ مغلّفٌ بالجلد، عُثر عليه تحت مقعدِ جوقةٍ منهار عام 1689، احتوى مخططاتٍ غامضة تُلمّح لطقوسٍ سرّية—دوائر مرسومة بالفحم ورموز تشبه أنابيب الأرغن. تكهّن بعضهم أن العرّافات الأولين قد قدّسوا الآلة بتعاويذٍ همسوا بها باللاتينية لاستغلال الحاجز بين الحياة والموت. حتى صرير المقاعد الطري بدا كأنه جزءٌ من لحنٍ مُعدّ، كما لو أن الكنيسة نفسها كانت تنتظر نداء الأرغن كمساعدٍ مخلص.
سجلات الحُرّاس الليليين
في سواد الساعات التي تسبق الفجر، تأوهت أبواب الكنيسة الثقيلة لتفتح وتستقبل الحارس الليلي فرانز مولر، رجلٌ طويل نحيف تفوح رائحته بلمسٍ خفيف من راتنج الصنوبر. كان عمله بسيطًا نظريًا: حراسة الصحن الفارغ حتى أول ضوءٍ للفجر. ومع ذلك كان كلُّ خطوةٍ له تدق كضربة مطرقة على حجرٍ مصقول، مرسلةً تموّجاتٍ صوتية تندمج مع سكون المبنى الأزلي. ارتدى حذاءً قويًا نعلاه مُنهَك من دروب الدوريات، وحمل فانوسًا يرقص ضوؤه على المقاعد المنحوتة كأرواحٍ قلقة. في مناوبته الأولى استعرض فرانز كل ظلّ في الكنيسة، متتبعًا الأقواس بعينين كأنهما تقيسان وزن القرون. لاحظ صدى أجراس بعيدة يترنّح على الحجر، رنةً منخفضة قد تكون من الريح أو من جماعةٍ لا تُرى وهي تصلي. ذاق الهواء في تلك الليلة رائحة بخورٍ بارد وطحلبٍ رطب يتسلّل عبر الحجارة الساقطة، نسيجٌ حسيّ يلتصق بالذاكرة كما يلتصق راتنج الأرز.
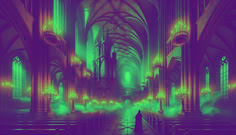
في غضون أسبوعين تعلّم فرانز توقع تحرّكات الأرغن. عند تمام الساعة 23:57، وكأن ساعةً شبحية قد دارت، أطلق لوح الدواسات نفسًا بيسًا وحيدًا انساب عبر الأرض كأنه نهرٌ من الدخان. كان الصوت أرق من نسيم صيفٍ ينساب بين أشجار الصنوبر الجبلية، ومع ذلك أكثر إلحاحًا من دقّات طبل الحرب. وضع فرانز ظهره إلى عمودٍ، أطراف أصابعه تلامس الحجر البارد، واستمع واللحن يتفتّح طبقة بعد أخرى. خربش ملاحظاتٍ في دفترٍ مهترئ على ضوء فانوسه، يأمل أن يلتقط نمط الفواصل والوقفات. تحت السقف المقوّس ارتفعت كل وِصلةٍ كنسورٍ تنشر أجنحتها ثم تدور لأسفل في أقواسٍ هابطة تشبه الشهب. حتى مقعد الأرغن تصدّى بصيريره مع الإيقاع، كما لو أن له رغبةً عابرة في العزف.
مع مرور الأسابيع صار نوم فرانز مسكونًا بمواضيع الأرغن، نزل إلى أحلامٍ مضطربة ترى الأنابيب تتلوّى كأفاعٍ وأصابع شبحية تحوم فوق المفاتيح العاجية. كان يدندن بمقاطع في لحظاتٍ غريبة—في السوق أو بين المخابز حيث يلوح عبير لفائف القرفة كرمزٍ للحياة العادية—ومع ذلك ظلّ ذكر برد الكنيسة الرطب يلازمه كظلّ، مذكّرًا إياه أن بعض الألحان تحمل ثقلًا يتجاوز النوتات. بدأت سمعة الحارس في التحلّي بالرصانة تتآكل، وهمس القرويون في أوساطهم أن فرانز صار رجلًا مربوطًا بمنتصف الليل. قال البعض إنه بات طليقًا في السكون، متقنًا الصمت كلغةٍ ثانية؛ وأما آخرون فحَسِدوه على شجاعته، غير مدركين أن الخوف قد رسخ في عروقه.
في مساءٍ عاصفٍ في الخريف، شقّت ريحٌ نحّتة عبر النوافذ المكسورة وأطفأت فانوس فرانز، غارقةً إياه في ظلمةٍ سحيقة. عادت نغمة افتتاح الأرغن بقوّةٍ لم تكن متوقعة، ملأَت الظلمة بمادةٍ حية تغذي المكان، كما لو أن عصارة الموسيقى تسري في عروق الكنيسة. في ذلك الفراغ من الضوء شعر فرانز بشعيرات عنقه تنتصب، كأن متفرّجين شبحيين تكدّسوا حوله. ثم، وفي صمتٍ مفاجئ، توقفت المفاتيح، ولم يبقَ سوى رذاذ المطر على السقف. عندما أضاء فانوسه من جديد وجد وردةً بيضاءً وحيدة موضوعة على مقعد الأرغن، بتلاتها رطبة وعطرة. عرف فرانز حينها أن الحارس صار مراقَبًا، وأن جمهور الأرغن غير المرئي يمتد إلى ما وراء حدود العالم الفاني.
كان سجلّه لتلك الليلة طمسًا من خطوطٍ مرتعشة ورسوماتٍ نصف مكتملة—مخططات لدواماتٍ نغمية تتحدى التدوين الكلاسيكي. شقّ خطوطًا على الهوامش بين نقاطٍ من شمعٍ مهدور تلمع تحت ضوء المشعل ككوكباتٍ صغيرة. عزَم فرانز أن يشارك ملاحظاته مع قاضي المدينة، لكن الخوف جمع شفتيه؛ من سيصدّق رجلًا يحاور الأشباح بالموسيقى؟ فبدلًا من ذلك عاد مرارًا وتكرارًا، يقوده مزيجٌ من الرهبة والافتتان. صارت الكنيسة—بأقواسها المكسوة بالصقيع وجوقها الصامتة المنحوتة في الحجر—ملاذًا وفخًا في آنٍ واحد، تشكّل قدره مع كل نغمةٍ منتصفية.
ليلة الجوقة الخفية
حمل سكون عشية عيد جميع القديسين في لوسيرن ثِقلاً أثقل من أي ضبابٍ يهوى السفوح الألبية. تأرجحت الفوانيس كيراعات ضوء بعيدة في الشوارع المرصوفة بينما اقترب السكان من كنيسة هوفكيرخه حاملين باقاتٍ صغيرة من الأعشاب وأزهار القطيفة. كان الهواء معبأ برائحة الحجر المبلل وعبق تحلل البتلات المتساقطة، عطرٌ غريب رافق مواكبهم الوقورة. في الداخل بدت الكنيسة بلون اللؤلؤ تحت وهج الفوانيس، جدرانها تنبض بجداريات تُصوّر قديسين غارقين في تأملٍ أبدي. أُزيحت خيوط العنكبوت عن المقاعد، وغُطّيت كل دكةٍ بمخملٍ أسود يمتص الضوء كريش الغربان. هنا، عند مفترق الأحياء والأموات، انتظر الأرغن لحظته.

نما صمتٌ مشحون بالتوقع حتى دقت أول رنةٍ لساعة الحادية عشرة، نغمتها تترنّح كتموّجٍ عبر بركةٍ ساكنة. انحنى الجمع، شفاههم تتحرك في صلاة صامتة، بينما في العلية تنفّست أنابيب الأرغن معًا. عند 11:59 انخفض مفتاحٌ واحد بلا إنذار، مطلقًا وترًا صافيًا بدا كأن السماء نفسها قد انفتحت. ثم فُتحت السدود الصوتية. اندفعت الموسيقى عبر الصحن كفضة منصهرة، تلفّ حول الأعمدة وتلتف حول الأضلع المرتجفة. رقص الضوء على نقوش الجدران البارزة، محوِّلًا الملائكة الحجرية إلى أشباحٍ متلألئة محبوسة في باليهٍ ماورائي. شَبَك بعض الحاضرين أياديهم المرتعشة؛ أغلق آخرون أعينهم مستسلمين لحنٍ أقدم من أي ذاكرة.
بينما علت النغمات، خرجت جموعٌ من الأشكال الشاحبة من التجاويف والزوايا، تخطو بتؤدةٍ إلى وهج القمر. ارتدت أزياءً بلون الرق البالي وتحركت بوقارٍ أزاح أيّ أثرٍ للخوف. فتُحت أفواههم في ترنيمٍ صامت، والنسيج الخافت لأصواتهم شكّل جملةً مقابلةً غير مرئية لكوردات الأرغن. فرانز، متربّعًا على شرفةٍ ضيقة، شاهد ببهجةٍ مهيبة كيف انجرفت الأرواح التي كانت مربوطةُ بالقيود البشرية إلى حريةٍ، حيّزُها يتلألأ كندى الصباح. شمَّ أضعفَ أثرٍ من رائحة الخزامى، كما لو أن الراحلين حملوا رموزًا من الحياة الأرضية معهم إلى الأبدية. دار الصراع بين الظل والمادّة تحت الأقواس القوطية، كل ترنيمةٍ تنسج خيطًا هشًا يربط الماضي بالحاضر.
بلغت الموسيقى ذروةً في تصاعدٍ هزّ الزجاج الملون، فتراقصت أشعةُ لونٍ متكسّر عبر أرضية الحجر كشقوق قوس قزح مكسور. ارتجفت مرايا الأنابيب المتلوّية، وكل نغمة توقظ أصداءً من السراديق أدناه. لوهلةٍ شعر فرانز بأنه بلا مرساة، يطفو بين نسمة السماء ونبضة الأرض. ثم دوت الوصلة الأخيرة، رنانةً ببطءٍ حتى بدا أن الصمت نفسه يتنهد ارتياحًا. تراجعت الظلال إلى العتمة، متبعة ممراتٍ غير مرئية عائدةً إلى أماكن خارج حساب البشر. في أعقابهم وقف الأرغن مهيبًا، مستريحًا بروحه حتى النداء التالي.
عندما لمست أنامل الفجر الشاحبة السماء تفرق الجمع بصمتٍ مذهول، وآثار أقدامهم على حجرٍ مصقول تحدد مسارهم. نزل فرانز الدرج الضيق إلى الصحن حيث كانت الوردة البيضاء الوحيدة ملقاةً على مقعد الأرغن، بتلاتها الآن ذابلة لكنها لا تزال متوّجة بندى الصباح. احتضنها برفق كمن يتلقى بركةً أخيرةً من أولئك المرتلين غير المرئيين. راجع نبأ تلك الليلة شوارع لوسيرن، وانسجمت في رسائل ودفاتر وحديثٍ هامسٍ في الحانات. صار سهر الأرغن منتصف الليل عهدًا بين العوالم، مؤكدًا وضع لوسيرن كمدينة يترقّق فيها الحجاب متى استيقظت الأنابيب القديمة.
الخاتمة
في القرون التي تلت، تحوّل أرغن الشبح في لوسيرن من أسطورةٍ هامسة إلى رمزٍ لرابطة المدينة الدائمة مع ما وراء الحواس. لا يزال الحجاج يتجمعون في عشية عيد جميع القديسين، وقلوبهم مفعمة بالدهشة وقليلٍ من الرهبة، مدفوعين بشائعات الانسجام الطيفي الصاعد من أنابيب كنيسة هوفكيرخه. ما زالت الآلة صامدة تحت رعايةٍ حذرة، مفاتيحها وأنابيبها المهترئة مُصانة بتوقيرٍ يكاد يلامس العبادة. يروي الزوار عن قشعريرة تسري في ظهورهم وهم يمرّون تحت الأقواس منتصف الليل، نصف متوقعين أن تتلألأ الوصلات في الهواء في أي لحظة. بينما يرفض المشككون الظاهرة باعتبارها حيلةً من الريح أو آلياتٍ مصدئة، يحمل من شهدوا الجوقة الشبحية قناعةً تتحدى كل تفسير. اليوم تظل الأسطورة خيطًا حيويًا في نسيج لوسيرن، تذكيرًا بأن الموسيقى قادرة على ربط العوالم وإيقاظ أصداء القلوب الخاملة. سواء بدافع الإيمان أو الخوف أو الحنين، يتسلّق الناس درجات الكنيسة مرارًا وتكرارًا ليقفوا تحت سقفها المقنطر وينتظروا تلك النغمة الوحيدة الأولى. وفي الصمت الذي يليها يصبحون جزءًا من تقليدٍ نُسج عبر الأجيال—سهرٌ يدعونا لنتساءل عمّا يكمن وراء حدود سمعنا.













