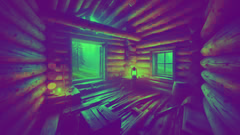المقدمة
ضغطت كلير راحة يدها على الباب الخشبي المهترئ، طلاءه متشقق ومتقشّر بعد عقود من العواصف والشمس والثلج. داخل الكوخ كان خافت الإضاءة، والهواء ثقيلاً برائحة الخشب الرطب وإبر الصنوبر التي هبت معه النسيم. وجدت هذا المكان على الإنترنت، مأوى صيد قديم في أقصى ركن من الغابة الشمالية، بعيدًا عن هدير السيارات وعيون الحكم. نادتها الوحدة بعدما أصبحت المدينة قريبة جدًا وتنفسها قصير، وكانت المواعيد النهائية والتوقعات خانقة للغاية. هنا، آثرت أن تكتب بحرية، أن تستعيد الوضوح الذي فقدته قبل أشهر. لا إنترنت، لا تغطية هاتف — فقط دفتر ملاحظات وقلم وبرية جامحة.
في أقصى آخر الغرفة الرئيسية، كانت نافذة قد سُدّت بدائية بألواح عريضة من الصنوبر المتآكل، معتمة بالعفن والقدم. حَجَبت الألواح المنظر الوحيد للغابة بالخارج، كما لو أن شيئًا ما أجبر سكان الكوخ السابقين على إحكام إغلاقهم بداخله. رغم الكآبة، شعرت كلير بجذب نحوها؛ كان الصمت حول تلك الألواح أثقل من أي زاوية أخرى في الكوخ. ارتعشت واقتربت. كانت المسامير صدئة والخشب يئن تحت أطراف أصابعها. لماذا يقوم أحدهم بتغطية نافذة بالألواح ثم يترك الكوخ؟ استدارت وأشعلت مصباحًا صغيرًا لتطرد الظلال المتجمعة. ارتفعت الريح بالخارج، واهتزت المصاريع، وللحظة ظنت كلير أنها سمعت طرقًا خفيفًا على النافذة خلف الألواح. تجمدت. جاء الطَرْق مرة أخرى — متعمّد، بطيء، وشبه فضولي.
خفق قلبها في صدرها، وجاءتها موجة من الشك والذعر. كان من المفترض أن يكون المكان خاليًا: لا حارس، ولا مارّون. حاولت أن تعقل الأمر وتقول إنه حيوان أو صدى للريح. ومع ذلك بدا الصوت شخصيًا، كما لو أن أحدًا يحاول التكلّم من ناحية الخشب. مرتعشة، فكّت حقيبتها بعناية، فرشت بطانية، رصّت كومة دفاتر، وأخرجت حاسوبها المحمول — عديم الفائدة في هذا الفراغ الرقمي لكنه كان يبعث على الطمأنينة. مع كل صرير في الألواح ومَجرى هواء على الباب، ضاق توتر كلير أكثر. أضاءت مصباحًا ثانيًا ووضعته على الطاولة المقابلة للنافذة المغلقة بالألواح. رقصت الظلال بين الألواح، وفي ضوء تلك المصباح بدا الظلام وكأنه حي.
كان العشاء حساءً معلبًا وبسكويتًا يابسًا، أكلته في صمت بينما الريح كانت تصرخ بالخارج. نقر المطر السقف بنغمات غير منتظمة. أجبرت كلير نفسها على الكتابة: الكلمات كانت متعثرة، وكل جملة معركة. سيطر عليها الطقس القاسي والعزلة على سردها. حاولت أن تركز على تاريخ الكوخ — سجلاته تقول إنه بُني في عشرينات القرن الماضي على يد عائلة اختفت في شتاء ما، ولم يذكروا سوى "أصوات غير طبيعية". كانت تلك الشائعات قد جذبتها إلى هنا أكثر من أي شيء آخر. كان قد فات الأوان الآن للرجوع. أغلقت دفتر ملاحظاتها واتكأت في كرسيها، تحدق في النافذة المغلقة كما لو أن نظرتها قد تكشف سراً كامناً. بعد لحظة طويلة رمشت. ثم عاد الطَقّ الخفيف مرة أخرى — متعمّد وإيقاعي. طَق... طَق... طَق.
خاطفة برق عبرت شقًا في الجدار الشمالي، تلاها رعد هز الأرضية. في ومضةٍ مؤقتة ظنت كلير أنها رأت حركة وراء الألواح — شيء نحيف، ممدود، يزحف في العتمة. شهقت والقلب يكاد يتوقف. لم تتحرك الألواح، لكن في تلك الومضة انزلق شيء عبر شق الزجاج المكسور في الأعلى. هل كان غصنًا؟ مخلب حيوان؟ كان البيت محكم الإغلاق، ومع ذلك علمت بيقينٍ غريب أن نافذة الكوخ المغلقة تخفي أكثر من الخشب المتعفن والمسامير الصدئة. باضطرام العاصفة وضغط الليل من حولها، أدركت كلير أن ما يعيش بالخارج لا يخضع للمنطق البسيط. كانوا يراقبون. وكانوا يريدون الدخول.
الشق في العزلة
قضت كلير صباح اليوم التالي تتفحّص الكوخ وما حوله مباشرة. خارجًا، بعد الدرجات المتعفنة والأدغال، كانت الغابة تطل شامخة وصامتة. كانت الطحالب تتدلّى من أشجار الصنوبر، وكانت سكون غير مريح تحت مظلة الأشجار. تسلقت منحدرًا بجانب الشرفة الخلفية، فوجدت فسحة صغيرة حيث دُوست آثار أقدام — آثار بشرية — في التراب الطري. كانت جديدة، وعميقة جدًا لتكون مجرد بقايا صدفة؛ اقترب شخص من الكوخ مؤخرًا. تسللت الخوف إلى ذهن كلير، لكن معه جاء أيضًا إصرار عنيد. خربشت ملاحظات: «علامات على زائر. لا آثار بعد الفسحة.» أي زيف خفيف للوحدة التي تخيلتها اختفى تمامًا.

داخلًا، كانت النافذة المغطاة تبدو كحارس صامت. خلعت كلير لوحًا لتتحقق من الزجاج الأصلي، فوجدته محطَّمًا، وِقَعَت الشظايا كالأسنان المسننة. لبست قفازات وجمعت الشظايا في قطعة قماش. لماذا تغلق نافذة مكسورة بدلًا من استبدالها؟ بدا كل دليل يغذي اللغز أكثر حتى كادت كلير تصدّق الشائعات القديمة: أن الغابة هنا لا تترك ضحاياها يرحلون.
أفاد راديو مهترئ بأن العاصفة ستستمر يومًا آخر. لا كهرباء، لا هاتف. ملأت قنينة الماء من حوض مغسلة مُصفرّ، وتمددت على سرير ضيق، لكن التعب لم يأتِ. كان النوم خطيرًا عندما يضغط شيء على الجانب الآخر من تلك الألواح. أشعلت شموعًا وسجلت كل صوت في دفترها — كل فرقعة للخشب المستقر، وكل هبّة على الأذواق — ولاحظت أنها دوّنت عشرات الطرقات والطَقّات منذ الصباح فقط. كان شيء يدور حول الكوخ، يختبرها، يخترقها. هل هو حيوان؟ إنسان؟ أم شيء آخر تمامًا؟
حل الليل بسرعة بعد انقشاع السماء، وثبتت كلير مسامير إضافية في إطار النافذة. ثم جلست على الكرسي بجانب الموقد، ملفوفة ببطانية حول كتفيها. بدأ عويل العاصفة من جديد. حدقت بقوة في النافذة المغلقة حتى دمعت عيناها. ثم، لا لبس فيه: طرقة واحدة، بطيئة. طَرْق. توقُّف. طَرْق... طَرْق. على الخشب نفسه، منخفضة وموزونة. كان شيء أو شخص يناديها. ضغطت كلير أذنها على الباب بحثًا عن جواب، لكن الكوخ لم يزد عن أن تأوه ردًّا. انسحبت ويدها تسرع قلبها.
كتبت: «إن كنت هناك بالخارج، فأنا لا أسمعك. إن كان شيء وراء هذا، اطرق بصوت أعلى أو ارحل.» وللحظة بدا أن العاصفة استمعت. توقفت الطرقات تمامًا. أبتلع الصمت الكوخ. انزلقت كلير إلى أحلام قلقة، حيث راقبتها شخصيات ظلّية من وراء الزجاج المكسور.
مع الفجر تراجعت شدة العاصفة. استيقظت كلير على سكون، الهواء بارد ورطب. هرعت إلى النافذة، وتسلخت كل الألواح، وحدقت في الغابة الهادئة. لا شيء. تسرب ضوء الشمس عبر الأوراق المتبرعمة. كان الزجاج المكسور مرميًا على الحافة، نصف مدفون في التراب. تنفست بعمق وقررت أن تغادر عند أول ضوء، متعهدة ألا تذكر ما سمعت. لكنها حين استدارت لفت نظرها شيء: حروف صغيرة نحتت بخشونة في إطار الخشب، كانت مخفية سابقًا بالألواح. C‑O‑M‑E H‑O‑M‑E.
علق أنفاسها. ذلك النحت لم يكن جديدًا؛ كانت القطوع قديمة وجفت مع الزمن. ومع ذلك بقيت الرسالة نعشة ببرودها: «عد إلى البيت». مررت كلير أطراف أصابعها في الأخدود، وقلبها يغوص بخوف لا تستطيع تسميته.
جمعت أمتعتها ونادت في الغرفة الفارغة: «من أنت؟» لم يرد سوى الصمت. ثم خلفها، في الزجاج المشقّق لباب الكوخ الأمامي، انعكاس واضح: وجهها هي، شاحبة ومرهقة — لكن ثمة زوجًا آخر من العيون لمعت خلفها، حيوية ومقصودة. التفتت، فلم يكن في الكوخ أحد.
فرّت كلير إلى الغابة، تاركة أحذيتها وحقائبها ودفترها وراءها. لم تعثر على الآثار مرة أخرى. وعندما نزع المسؤولون الألواح لاحقًا، لم يجدوا أي دليل على اقتحام، فقط همس كلمات النحت. لم تعد كلير أبدًا، لكن أحيانًا في الليالي، يدّعي غرباء في مدن بعيدة أنهم يسمعون طرقات هادئة تتسلل عبر نوافذهم.
لقاءات مرعبة
مرت أسابيع بعد هروب كلير، ومع ذلك ظلّ طيف النافذة المغلقة يطاردها. حاولت العودة إلى شقتها، مواصلة كتابة روايتها، لكن في كل مرة أغلقت فيها عينيها كانت ترى تلك الرسالة المنحوتة في الخشب: «عد إلى البيت». اقترح معالجها اضطراب ما بعد الصدمة، وأن عقلها يستحضر أوهامًا لمواجهة الخوف. أومأت كلير لكن كانت تعلم أن شيئًا أكثر قد حدث — شيئًا مستحيلًا.

في محاولة لاستعادة توازنها، حجزت إقامة قصيرة في فندق صغير بالقرب من نفس المنطقة، على أمل أن النور والناس يطردان رهبتها. كانت المضيفة لطيفة — امرأة مسنة اسمها مارثا — تقدّم خبزًا طازجًا وتحكي قصصًا عن الغابات المحيطة. لكن عندما ذكرت كلير الكوخ المغطى بالألواح، شاخت ملامح مارثا. همست وهي تمسح يديها بمنديلها: «ذلك المكان فارغ منذ عقود. يقولون إن المالك الأصلي مات في العاصفة، ولا أحد يجرؤ على العيش هناك. ليس منذ اختفاء الأطفال.»
اختفاء الأطفال جعل كلير تشعر بوخز بارد في صدرها. «أطفال؟» سألت. أومأت مارثا. «أخ وأخت. قال الناس إنهم سمعوا طرقًا من داخل الكوخ، كأن أحدًا يناديهم عبر الزجاج المكسور. تسلّل الأطفال ليلًا، واختفوا بين الأشجار. فرق البحث لم تجد أثرًا. يقول بعضهم إن الغابة ابتلعتهم؛ ويظن آخرون أنهم وجدوا مأوى في مكان آخر. لكن الوالدين أبقيا النافذة مغلقة، على أمل الاستماع إلى نداءات أطفالهما. وفي النهاية رحلوا، وتركوا الكوخ مهجورًا.»
غادرت كلير الإفطار في حالة ذهول. تاريخ الحزن المربوط بتلك النافذة، مكان تتحول فيه الشوق إلى طرقات وهمسات، دبّ في رأسها بينما تتردد كلمات مارثا. طوال الوقت اعتقدت كلير أنها كانت وحيدة. بدلًا من ذلك، سقطت في إرث الكوخ التراجيدي — نداء حزين يفتن. كم من آخرين سمعوا تلك الطَقّات والخدوش؟ كم أجاب؟
مصممةً على مواجهة خوفها، عادت كلير مع حلول الغسق إلى فسحة الكوخ. لم تكن هناك عاصفة تلك الليلة، فقط قمر مكتمل يلامس قمم الأشجار. ارتفعت النافذة المغطاة ككتلة داكنة. اقتربت وهي تحمل فانوسًا صغيرًا. ارتجفت ساقاها لكنها تشدّدت: «لستُ أنتِ»، قالت بصوت مسموع. «لن أختفي. لن أضيع.» مرّت بأطراف أصابعها على الإطار حيث بقي نقش «عد إلى البيت». ثم لمست الألواح — صلبة، بلّوطٍ قديم. حاولت دفع لوح جانبًا لكنه ثبت بقوة. انهمرت دموع دون قصد. همست: «سأغادر.»
ردًا، جاء رفيف خفيف: طرقتان بالقرب من صدغها. انتفضت كلير ونظرت حولها. لا شيء سوى الظلال. صرخ الباب. حرّكت فانوسها؛ تراقص الضوء الكهرماني عبر الشظايا الزجاجية. ثم، يا إلهي، في ذلك المرآة المشوّهة رأت فتاة صغيرة تطل من الداخل، وجهها شاحب، وشعرها مضفر بعقد متشابكة. كلير أخفت صرختها. مالت الفتاة برأسها وطرقت مجددًا. طَق... طَق.
التفتت كلير وركضت نحو سيارتها المتوقفة على الطريق الطيني. كانت أنفاسها متقطعة. عندما وصلت إلى باب السائق لمحت عبر كتفها في ضوء القمر خلف الكوخ عدة أشخاص واقفين بلا حراك — طفل وطفلة، شاحبان في ضياء المصباح. فتحا شفتيهما كأنهما يريدان الكلام. رفعا يدهما ودّاعًا أو أمراً. ثم انفتحت النافذة المغطاة فجأة. انقلبت الألواح لما بدا كقوة لا تفسَّر، تنكسر داخليًا. سقطت الشظايا كالمطر عند قدميها. خلف الإطار المكسور، لم يكن هناك سوى عتمة فارغة. قفلت باب سيارتها وانطلقت.
من الطريق شاهدت الكوخ يبتعد داخل الغابة. لا أضواء، لا حركة. فقط صدى الطَقّات يذوب في البعد. ومع شروق الشمس، اختفى الكوخ تمامًا — لا أثر للخشب ولا للبناء، كأنه لم يوجد قط. مكانه كان فسحة مرتبة من الطحالب وشجيرات صغيرة.
لم تعد كلير إلى المنطقة. لكن في أحلامها المتأخرة تسمع الطَقّات على نافذتها — بطيئة، مُلحّة، تتوق لأن تُسمع مرة أخرى.
الانكشافات
بعد أشهر، جلست كلير في شقتها الجديدة تحدق في صفحة بيضاء على حاسوبها المحمول. ظلّ كتلة الكاتب مستمرًا، ورعب تلك الليلة ما زال عالقًا في ذهنها. قررت أن تعيد فحص كل التفاصيل: صور من هاتفها، ملاحظات في دفترها. حينها لاحظت شيئًا أغفلته سابقًا: الطوابع الزمنية في لقطات الكوخ كانت غير متناسقة. بعض الصور مضبوطة على الساعة 12:00 صباحًا أو 12:00 ظهرًا، مع أنها كانت تتحقق من الساعة قبل كل تصوير. وأكثر إثارة للقلق، أن الصور التي التقطتها داخل الكوخ أظهرت فروقًا طفيفة: في بعضها ترتيب الأثاث تغيّر قليلًا؛ وفي أخرى وقعت الظلال بزاويا لا تتطابق مع موضع الفانوس.

بدافع حدس، حمّلت كلير الصور على التلفاز وكبّرتها. في صورة للنافذة المغطاة قبيل الفجر، لم ترَ انعكاسها بل رأَت ظل امرأة واقفة خلفها، مرئية عبر شق الزجاج المكسور. رمشت كلير. كانت الطابعة الزمنية تشير إلى 3:14 عصرًا، مع أن الخارج كان حالك الظلمة. من كانت تلك الشخصية؟ فتشت في صور أخرى: نفس المرأة على سريرها خلف الكاميرا، شعرها مربوط إلى الخلف، مرتدية قميص نوم قديم. الوجه كان مغطى، لكن وضعية الجسد كانت تطابق الفتاة ذات الضفائر.
ارتفع نبضها بينما تقاطعت المعلومات مع وصف مارثا للأشقاء المفقودين. لم يُعثر قط على الولد والبنت. تحكي الأسطورة أنهم اختفوا في ليلة واحدة، وأن والدتهم، التي جنَّت من الألم، أغلقت النافذة لحبس أصواتهم بداخلها ثم اختفت أيضًا. أدركت كلير برعب أن المرأة في صورها لا يمكن أن تكون إلا تلك الأم، باحثة إلى الأبد. وكانت هي تلتقط صورًا للماضي بقدر ما تلتقط للحاضر.
نشرت كلير الصور على منتدى للكتاب طالبة المساعدة. انهالت الردود: بعضهم قال تدخل خارق، وآخرون أرجعوا الأمر إلى خلل رقمي. لكن غريبًا واحدًا راسلها مباشرة: «نشأت قريبًا. ذلك الكوخ ليس على أي خريطة رسمية. الناس يرونه في أوقات غريبة لكنه لا يبقى. ينجرف، يظهر لمن يحتاجون ملاذًا — حتى يعثر عليهم الحزن. لم تكوني وحدكِ أبدًا، كلير. المكان ناداكي لتصبحي جزءًا من إرثه.»
حبسَت أنفاسها. الشاشة أمامها أضاءت بتلك التفسير المريب، وفهمت الحقيقة النهائية: لم يكن الكوخ مهجورًا — كان بابًا. بوابة بين عوالم مشوّهة بالحزن. ظنت نفسها المحققة، الكاتبة، لكنها كانت هي من تُفحَص. لم تكن الألواح تمنع شيئًا من الدخول؛ بل حبستها فيها. وعندما هربت، صارت جزءًا من الحكاية، فصلًا آخر في قصة لا تنتهي عن الشوق والفقدان.
نظرت إلى ضوء المدينة من نافذتها، شاعرة بثقل مشاهدين غير مرئيين يضغطون من الأقرب. رن هاتفها بإشعار: شخص وضع علامة عليها في صورة من منشورها الليلة الماضية. فتحتها. هناك، واقفة خلف مكتبها في شقتها، كانت المرأة في قميص النوم، شاحبة كقمر، ضفائرها مفكوكة، تمد يدها نحو كلير بابتسامة يائسة.
أسقطت كلير هاتفها. تشققت الشاشة. في الزجاج المكسور لم ترَ انعكاسها بل ألواحًا فارغة، الخشب يحجب العالم. ثم جاء الطَقّ البطيء والواضح: طَق... طَق... طَق.
الخاتمة
لم تنشر كلير القصة التي كانت تقصدها. بدلًا من ذلك وضعت حاسوبها جانبًا وانتقلت عبر البلاد، يائسة لتفلت من الصدى الذي تبعها إلى البيت. لكن الطَقّات استمرت — خافتة في البداية، ثم أعلَنَت بصوت أعلى، كأن نفاد الصبر نما. في الليل تسمعها على نافذة غرفة نومها في الطابق العلوي من بيتها الجديد. طَق... طَق... طَق. في كل مرة تقف متّكئة على الزجاج وتهمس: «لن أعود.» ومع ذلك تواصل الطَقّات إصرارها، نابضًا كقلب يتوق إلى الإفراج. وأحيانًا، في أعماق البيت، تقسم أنها تسمع أصابعًا تخدش ألواح نافذة غير موجودة. حتى الآن، تتساءل كلير إن كانت قد هربت فعلًا — أم أنها مجرد لوح آخر في قصة ذلك الكوخ، ينتظر وقته حتى العاصفة القادمة.