مقدمة
شَعَرت كاميلا أورتيغا بالبشارة الأولى عندما تفرقت زوابعُ غبارٍ عبر الطريق السريع 281 مثل أشباحٍ مذعورة، تدور حبيباتُ التراب فتطعم لسانها بطعمٍ معدنيٍ كالنحاس. كانت تفصلها ثماني ساعات وبعُمق حياةٍ كاملة عن أفق هيوستن الزجاجي، وهي تنزلق نحو أراضي الحدود حيث كان زيز يرنُّ بصوت أعلى من أجراس الكنائس وكانت رائحة نبات الكريوزوت المحروق تلصق بكل شهيق. كان مكيف الجيب المستأجر يئن، ناشرًا عبقَ الفينيل المتشقق وقهوةً قديمةَ التصاق في دواسات السيارة—شبح لمطعم طريقٍ من مقاطعتين مضت. أمامها تلوَّنَت أرويو أوسكورو في حرِّ الصحراء، مجموعة أسطح صفيحية وجدران حجرية ملتصقة بفضة نهر ريو غراندي المتعرجة. كانت كاميلا قد حلفت ألا تعود إلى البيت، لكن سلسلة اختفاءات—طفلان اختفيا من حفل بلوغٍ على ضفة النهر، وعامل مزرعة وُجِد مخدوشًا وشفتاه زُرقتان—جَرَتْها جنوبًا كما يُجرُّ سمكٌ مُصطاد. همس أهل البلدة باسمِ لا يورونا بين رشفات ماء الكركديه، مُدَّعين أن المرأة الباكية تجوب المكان مجددًا، بعينين مجوفتين وجائعة. شدّت كاميلا قبضتها على المقود، ومفاصل أصابعها شاحبة كخزف العظم، وتذكرت صوت جدتها: «ابتعدي عن الماء بعد الغروب يا ابنتي؛ للنهر ذاكرة.» اصطدمت كرة عشبية بالمصد، تفتتت كصفحات جريدة قديمة، ورعدٌ دبّ خلف سلسلة جبال سييرا فييخا، جالبًا رائحة الأوزون الحادّة لعاصفة على وشك الانقضاض. مدت يدها إلى جهاز التسجيل المهترئ—نقرة، همهمة، دقّة الشريط المغناطيسي المطمئنة—ومضت في طريقها، غير مدركةٍ أنه مع بزوغ الفجر سيقايض النهر سرًّا آخرَ مقابل صرخة ويترك قصتها مبللةً بماءٍ باردٍ كالقبر.
همسات تحت شجر المسكيت
انفتح الفجر التالي كخوخةٍ مفرطة النضج، سكب ضوءًا برتقاليًا على الشارع الرئيسي الوحيد في أرويو أوسكورو. خرجت كاميلا من موتيلها—مستطيل منخفض من كتل الأسمنت تفوح منه رائحة المبيض والعفن—إلى هواءٍ كثيفٍ يكاد يُشرب. تجمّعت قطرات العرق عند ثنية مرفقيها قبل أن تصل إلى موقف الحصى. تنهّدت قاطرة شحن بعيدة، صوت بوقها كالمفصل المصدي في السماء، وامتزجت رائحة الديزل بأزهارِ الهايساش المتفتحة حتى وخزت أنفها.
مقهى إل غالو روجو كان يجثم تحت مظلّة مموجةٍ مطلية بلون نبيذ سانغريه دي تورو المجفف. مراوح السقف داخله تدور دوائر كسولة، تقطع رائحة القرفة والبيلونسيو وعجين المَسا المقلي إلى طبقاتٍ مرحبة. ديلفينا سالازار—بضفائر سوداء كالغراب وميدالية ذهبية للقديس بنديكت—دلفت بكأس فخاري عبر فورميكا مخدوش. «الناس يقولون إنك ناوية تعبثي بعش الشيطان»، تمتمت، والدخان يلوح حول كلماتها. جدران المقهى—طلاء نعناعي متشقق كقيعان البحيرات الصحراوية—اهتزت بأحاديثٍ منخفضة: رعاة يتبادلون السخريّات، واثنان من عناصر دورية الحدود يرتشفان قهوةً سوداء أظلم من خطيئة منتصف الليل.
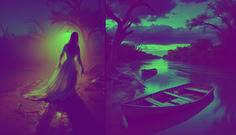
قلبت كاميلا دفتر ملاحظاتها إلى صفحة جديدة تفوح منها رائحة حبر الطابعة ونشارة الأرز. تحدّثت ديلفينا أولًا عن أرتورو فيلازكيث، الميكانيكي الذي كان ضحكه يهزّ الجدران كالرعد في صوامع الحبوب. اختفى أرتورو بعد رحلة صيد سلور منتصف الليل، وُعثر على قاربِه يطفو ومعه فقط قطعة تبغٍ نصف ممضوغة وشرّ دمٍ رقيقة تشبه نبيذًا مسكوبًا. «النهر أحبه أكثر من اللازم»، همست ديلفينا، وعيناها تعكس وهج المصابيح الفلورية. تدخل راعٍ مسنّ: اثنان من أبناء العم المراهقين، ماتيو وإغناسيو، تخلّفا عن قداس الأحد ليتسبحا تحت بدرٍ مكتمِل؛ وفيما بعد رفضت كلاب البحث الاقتراب من الضفة الموحلة، ذيولها مكتوفةً وأنينها مسموع. التقط جهاز تسجيل كاميلا كل مفردة، والشريط ينسدل بصوت همس بلاستيكي خفيف.
في منتصف المقابلة، انغلق باب المطبخ من تلقاء نفسه—خشبٌ يصطدم بالإطار بصوتٍ مكتوم يشبه ارتطام جمجمة ثور بالسياج. ازداد فرقعة الزيت المقلي، حاملةً معها اللذعة القاسية لبذور الفلفل المحروقة. عملت ديلفينا علامة الصليب. «عندما تكون لا يورونا قريبة، الأبواب تتكلم»، قالت بصوتٍ متهدج متصدع. بصق فلاح على طاولة الزاوية تبغًا في كوب من الفوم وقال متمهلاً: «سينجمد نصف فدان الجحيم قبل أن أضع قدمي على ضفة هذا النهر مرةً أخرى. ستسحبك أسرع من فاتورة بار يوم استلام الراتب، سامع؟» تناثرت العبارة في الغرفة الرطبة كعثّة.
خارجًا، كانت دورية الشريف المغطاة بالغبار متوقفة، ومكيفها يطن. خرج النائب راؤول سيردا، وأحذيته تخدش الحصى. تفوح من زيه رائحة زيت البنادق والمنثول. وافق على الإدلاء ببيان رسمي فقط إذا أطفأت كاميلا الكاميرا. ثلاث جثث مفقودة في هذا الربع وحده؛ كل القوارب التي عُثر عليها كانت فارغة، ووسائد المقاعد مخدوشة كما لوّها أظافر يائسة. نقر على حافة قبعته—حلقة العرق والملح واضحة حولها—وهمس: «بعض المسالك لا تستحق الركوب، آنستي.» لاحظت كاميلا ارتعاشه؛ كان الخوف هنا كثيفًا كسِمغ المسكيت.
عند الظهيرة خَلا المقهى. بلغ الحرُّ أوجه، وصرخ الزيز حتى بدا كأن كل عارضة خشبية تهتز. كانت ملاحظات كاميلا تفوح منها رائحة الحبر وشحم التورتيلا. خرجت إلى ضوء الشمس الذي بسط العالم كما الصورة المتركّة في صندوق القفازات. فوقها، حلق النسور في دوائر كسولة على شكل ثمانية، وظلالها تزحلق على الرصيف المتشقق كأفكار سوداء. أدركت أن كل اختفاءٍ كان يشترك في توقيتٍ واحد: بين الحادية عشرة ليلًا والثالثة فجرًا، حين تتحوّل تهويدة النهر إلى إغراء. في مكانٍ ما ضمن هذا النطاق، تحوّل حزن لا يورونا إلى جوعٍ مُتَرَقٍ.
هبَّت رياحٌ فجأة حاملة رائحة طين النهر، رطبة وغنية بالحديد، كأن نهر ريو غراندي قد زفر. بقيت تلك الرائحة في شعر كاميلا بينما انطلقت إلى مكتب الشريف، وجدران الطين تتصبب عرقًا من الحر. بداخله اهتزت مصابيح فلورية وامضة. لوحات الأدلة عرضت صور بولارويد: صنادل أطفال نصف مدفونة، أثر حذاء رجل ينتهي عند حافة الماء، تموجات مُجمّدة بفلاش الكاميرا. لمست كاميلا صورة ملطخة بإبهامها فشعرت، تحت سطحها اللامع، بذبذبةٍ طفيفة—كنبضة قلب محبوسة في سيلولويد.
لاحقًا، وحيدة في موتيلها، شغّلت شريط اليوم. بين جمل ديلفينا تنسّلت شهقة باهتة، صوت لم تستمع إليه خلال اللقاء—نوح طفولي يسبح تحت ضجيج المقهى. رفعت الصوت؛ اشتدّ النوح حتى ارتفعت قشعريرة على ذراعيها. كان صوت مَن ينوح على جانب الهوّة، نغمة مشدودة إلى حد الرِقّة كسلك شائك في الريح.
كانت ساعة السرير تشير إلى 11:08 ليلًا. في مكانٍ خارج، خلف وحدة التكييف الهاجة، تعطر الليل فجأة رائحة قصب النهر وزهور الزنبق المتحللة. أغلقت كاميلا جهاز التسجيل ويديها لزجتان، وفهمت أن الحدود بين القصة والخطر تَضيق، نبضة قلبٍ تلو نبضة.
أصداء جرح قديم
تشابكت خيوط البرق عبر الأفق الغربي بينما دفعت كاميلا جيبها صوب رانشو دي لا لونا، أطلال من عصر البعثات الإسبانية على بعد ثمانية كيلومترات في مجرى النهر. تحوّل الطريق إلى كاليش متعرج؛ كل حفرة صدمتها أوجعت عمود ظهرها وطرحت رائحة غبارٍ مبلول بالمطر داخل المقصورة. صرخ طائر الليل تحت أشجار السنديان الحية، كالمفصلات الصدئة تتوسل لزيتٍ. عندما أطفأت المحرك أخمد الصمتُ حولها، كثيفٌ ومتوقّع، لم يكسره سوى خريرٍ بعيد لطائرٍ ليلي.
برزت الهاسيندا، جدران طينية منهارة جزئياً تتوهّج بلون مريض تحت وميض البرق. تسلقت زهور الكروم البرتقالية الأقواس المتداعية، وأطلقت عبقًا فلفليًا في الهواء الرطب. داخلها سكَب ضوء القمر عبر سقف منهار، متجمعًا على بلاطٍ متشقق كزئبقٍ مسكوب. كشف شعاع مصباحها نافورة معمودية مخضبة بالطحالب وفوقها لوحة جدارية محوّرة بنصفها بفعل الزمن: امرأة بفستان عروس أبيض ترفع طفلين نحو شمسٍ شقّتها سحب. تقشّرت الطبقات الطلائية بانحناءاتٍ تنبعث منها رائحة الغبار الطباشيري وحزنٍ عتيقٍ منذ قرون.

أطارت ملفات الأرشيف المحلي—مجلدات مغبرة تُثير هرش أنفها—قصة دونيا سوليداد زامورا، وريثة عام 1871 التي تحولت إلى منبوذة. خُدِعت من قِبل رانسيرو متزوج كانت كلمات مديحه تفوح منها رائحة خمور الصالة، فطعنته، وفق الأسطورة، بمقص خياطة في شريان الرقبة ثم غرقَتْ أطفالها واغرقت نفسها في النهر. تباينت الروايات فيما إذا قبل ريو غراندي جثتها أم رفضها؛ وصفت صحف الجانب المكسيكي جسدًا جرفته الأمواج إلى الشاطئ، ووجهه مشوَّهٌ في صرخةٍ تُخثِّر اللبن في الحظائر القريبة. تصوّرت كاميلا ماء تلك الليلة: أسود كالحرير، باردٌ كبلاط السرداب، يبلع انعكاسات الفوانيس كما يبتلع النفس.
مسحت قطعة من الجدارية؛ علّق رَمل تحت أظافرها، وشعرت بنبضة باردة تصعد إلى معصمها كما لو أن الجدار يتنفس على جلدها. فجأة عمّ سكون—فاقت الزيز نصف خرخشتها، لتبقى الغرفة معلقةً بفراغ. تفتَّحت رائحة ماء الورد بخفّة، سابقةً كعطرٍ في سرداب. خفق مصباحها؛ وفي الظلام الومضي لمحت شكلًا—عروساً مبللة، والدانتيل يلتصق بكتفيها الهزيلين—واقفةً حيث يلتقي ضوء القمر بالظل. تخلّت كاميلا إلى الخلف، وحذاؤها يخدش شظايا فخارية. عندما استقرت شُعاعَ المصباح كانت الظهرة قد اختفت.
قلبها دق كمنبّهٍ ميكانيكي، ضغطت زر التسجيل في جهازها المحمول. «إن كنتِ هنا، دونيا سوليداد، أريد أن أروي قصتكِ»، همست، صوتها مرتعش. بدأ المطر، قطرات سمينة تفوح منها رائحة قصدير وغبار لقاح المسكيت. على الشريط، لم يَجبها سوى تنفّسها. ثم، برقة طرف إصبع على زجاجٍ مبتل: «أطفالي؟» خشخشت الكلمة في العوارض. هبّةٌ حملت رائحة طين النهر وزنابق متعفنة، والجدارية ذرفت حبة ماء واحدة على خد الأم المرسوم.
فرّت كاميلا في العاصفة. خارجًا، فرقع الرعد بقوة حتى شعرت وكأنه يصفع طبلة أذنها. سحبت باب الجيب مفتوحًا؛ بدا جلد المقعد لزجًا كما لو أن جسدًا مبللاً قد شغره لتوه. انعكاسها في مرآة الرؤية الخلفية كان لشخص غريب—عيون واسعة، شعر ملتصق بمقابِل الجبين. أثناء رجوعها إلى الخلف رنّ برج الجرس المهدّم في الهاسيندا: دقةٌ مجوفة واحد، رغم أن الجرس البرونزي كان قد سقط منذ عقود. انطلقت، عجلاتها ترشّ الطين، وقلبها يدق بصخبٍ غطّى أغنية رانشيرا المشروخة القادمة من الراديو.
عادت إلى موتيلها في الساعة 3:12 صباحًا ورفعت الصوت الرقمي. خطوط الطيف الهزازة وميضت بالأحمر حيث بلغت الترددات ذروتها—هناك، همسة كلمة «أولادي». شغّلت التسجيل مرّة أخرى؛ تحت تلك الكلمة التقطت صوتاً خفيفاً لبلل ماء يغلق فوق رأس صغير، تلتها نشيجات بعيدة. جذبها التعب، وعيونها محشوة برمال السهر، لكن استقرت فيها حقيقة: لا يورونا ليست أسطورة فحسب—بل جرح لم يجلد، يسرّب الفقد إلى كل جيل. خطّت كاميلا في دفترها حتى الفجر، والحبر يفوح منه رائحة الفولاذ والمطر، وامتلأت الصفحات بروابطٍ محمومة: أقارب زامورا، ميكانيكيون مفقودون، أطفال غرقى، كلهم حبات على نفس المسبحة الدموية.
ليلة الريح الناوحة
بعد ليلتين ارتفع منسوب ريو غراندي خمسة أقدام في ست ساعات، منتفخًا بمياه جريان الجبال. أغلق الشريف سيردا الوصول إلى النهر، لكن مراهقي أرويو أوسكورو سخروا من التحذيرات—كان منحنى النهر عند إل كودو طقسَ عبور. صفّنت كاميلا سيارتها على جرف من الشيل يطل على الانعطاف، وميكروفونها البارابولي موصول ببطاريات جديدة. ضغط الهواء على جلدها، رطبٌ كغسالة ملابس، ويحمل طعماً مرًّا لشرارة البرق المخبوزة بالأوزون فوق الشجيرات.
في الساعة 9:17 مساءً، انزلقت أضواء خلفية لشاحنة عبر المسار الترابي: ثلاثة أولاد وفتاة تضحك، كلهم يستمعون لروك إسباني، كلهم تباهٍ وتهور. غمسوا أنفسهم في الضحلات، محدثين تموجات فسفورية تفوح منها رائحة الطحالب والطين المقلوب. التقط جهاز تسجيل كاميلا صيحاتهم. تكوّمت الغيوم فوقهم كالفيلق؛ الرعد أزبد بصوت جهوري منخفض. هبت الريح، رافعة رمل النهر الخشن الذي وخز خديها. شدّت سترتها بإحكام، نفَس القماش يفوح منه غبار وعرق التوتر.

الساعة 10:03 مساءً. هدأ الجو. استندت الفتاة—إيزابيل ريفاس—على داخليّة مطاطية، شعرها لامع كالريش. ثم انطلق صوت، صرخة تشق الظلام، عالية وحزينة، ترتفع كبخارٍ من قاع جفافٍ متصدّع. «أين أولادي؟» حملت العبارة عبر الماء، ناسجةً بين جذوع المسكيت. تجمد المراهقون، مضحكاتهم خمدت أسرع من عود كبريت يُطفأ في ريح العاصفة. ارتفعت مستويات الميكروفون لدى كاميلا حتى لَمَحَت اللون الأحمر الدموي.
أضاء البرق النهر: في مركزه، امرأةٌ ملفوفةٌ بالدانتيل الأبيض، القماش ملتصق بجسدها كما العشب البحري بجذع طافية. شعرها—داكنٌ كالماء وطويل حتى الخصر—يطوف حولها، وعيونها حُفَرٌ توأم من طين قاع النهر. رفعت ذراعين هزيلتين؛ تساقط الماء عنها بطبقات لامعة. شتمَ الأولاد، وتهافتوا نحو الضفة. صرخت إيزابيل—صوتها خامٍ بما فيه الكفاية ليقشر القلوب—وتمخطرَت. الظِلّ انزلق بمعنى آخر، يقترب بخفّةٍ مستحيلة.
انطلقت كاميلا نزولًا عبر الجرف، حذاؤها ينزلق على الشِيل المفكك. مع كل خطوةٍ انبعثت رائحة الكبريت الحجرية. صرخت عليهم أن يقبضوا الحبل المتأرجح، وصوتها مجرّداً. تعثّر أحد الأولاد، وبطْن ركبته اصطدم بالصخرة؛ اندمج صراخه مع عويل الريح، لا يُفصَل. انقلبت داخليّة إيزابيل— splash، شهيق مكتوم، ثم لا شيء سوى فقاعات. وصلت كاميلا إلى الضفة؛ لامس ماء النهر باردًا ساقيها، تفوح منه رائحة زنابق متحللة وزيت ديزل. مدت غصناً نحو الصبي المتخبط؛ تشبّثت أصابعه، مفاصلها صارخة البياض. كان الشكل بالدانتيل يحوم على بعد أمتار، وجهه مشوَّه بالحزن، ودموع تنهمر دون أن تخفف من ماء النهر.
«كفى!» صاحَت كاميلا. مال رأس الطيف—بمنظرٍ يشبه الطير—ولحظةً بدا أن الحزن طغى على الجوع في تلك العيون السوداء. دفعت كاميلا جهاز تسجيلها أمامها كما لو أنه صليب. «سأرويه لهم»، تعهّدت، وصوتها يرتجف كذيل أفعى. «سأجعلهم يتذكرون اسمكِ.» توقف النحيب. تلاشت الريح. سكن النهر كما لو أنه يحبس أنفاسه. تفجّرت ثيابه كزهرةِ بِيونيَّةٍ بيضاء، وبزفرةٍ تفوح منها رائحة الورود الممزوجة بالمطر، غاصت تحت السطح. انطوى الماء، تكوّر، ثم صرف نفسه لمرآةٍ زجاجية.
ارتدت إيزابيل إلى السطح، تسعل رمال النهر، وأظافرها تخدش ذراع كاميلا. سطّ الضوء الكاشف الخاص بالشريف سيردا، ومحرك الديزل يزمجر. سحب المراهقون أنفسهم إلى الشاطئ، بشرة بعضهم مشققة، وشفاهٌ ترتجف بلون أزرق رمادي. فوقهم تلاشى الرعد، فأصبح صوته أشبه بمدفعية بعيدة تختار الانصراف عن ساحة المعركة. سقطت كاميلا، سروالها جينز مبلّل يلتصق بها، وقلبها يرتد داخل قفصها.
أصرّ الشريف على ألا تذكر أي إفادة وجود أشباح—«لن أتحمّل أن يسخر منا الفيدراليون ويمحونا من الخريطة، سمعتِ؟»—لكن شريط كاميلا كان له رأي آخر. في غرفتها، والدفاية تفوح منها رائحة غبار محترق، راجعت الأوديو: صرخات المراهقين، الرعد، وتحت ذلك امرأة تدندن تهويدة. تدفقت كلماتها الإسبانية ناعمة كطين النهر: نمْ أيها الطفل، نمْ؛ الأم هنا، الأم قريبة. انتهت الأغنية بشهقة حادة تكاد تقطع الزجاج، ثم—صمت.
كتبت كاميلا حتى بزوغ الفجر، أصابعها على لوحة المفاتيح تصدر طقطقة تشبه الكستانيت البعيد. جدّلت حقائق الأرشيف، المأساة المعاصرة، وذاكرة النهر المتواصلة إلى سردٍ ينبض بحزن ماء البحر. كان طعم كل جملةٍ على لسانها كالحديد، ومع ذلك واصلت، عارفةً أن بعض القصص يجب أن تُروى حتى لو أنها تشرّح الراوية أثناء السرد.
خاتمة
عندما انسحبت مياه الفيضانات بعد يومين، تركت خلفها سيقان نبات القصب منحنية كمن تاب، وضفة نهرٍ مُزخرفةٍ ببصمات أقدامٍ حافية صغيرة توقفت عند خط الماء. لم تطفو أي جثث، رغم أن الشائعات قالت إن قطعة قماش—دانتيل أبيض مغطى بالطحالب—علِقت بجذر صفصاف قبل أن تذوب مثل السكر. دوَّنت كاميلا قصّتها؛ الصحف الإقليمية نشرتها تحت عنوانٍ: «المرأة الباكية أم لعنة مائية؟» انقسمت ردود الفعل أسرع من سياج مسكيت في حرّ أغسطس. سخر الشكّاکون من "خرافات حدود المقاطعة"؛ وأمُّهاتٌ نائحات ضغطن الصدادات على الصفحات يهمسن بالدعاء. أغلق الشريف سيردا موقع إل كودو إلى أجل غير مسمّى، ومع ذلك لا زال الشباب القلق يتحدون التيارات تحت ابتسامة القمر الرفيعة. أقامت كاميلا أسبوعين، أحذيتها الرياضية تدوس طين نهر جاف عند كل غروب. بعض الليالي كان تنهيدة خفيفة تعبر السدول وتمتزج بعوى ابن آوى؛ وأحيانًا كان يجيبها فقط نبض الماء البطيء. قبل أن تغادر، أهدتها ديلفينا جرة من خلطة بهارات قهوة دي أولّا—يانسون، بيلونسيو، قرفة—«لتدفئها» كما قالت. تبعت رائحة الخلطة كاميلا حتى طريق الولاية 35، تذكيرًا بأن القصص، كالجِدْيان، ترفض نهايات مرتبة.
في أوستن أعادت تشغيل التهويدة لمهندس صوت؛ عزل أنغامًا خافتة: رَشّات رضيع، نبضة قلب، وهمسة: «لا تنساني أبدًا.» ضحِكَ المهندس ساخراً، لكن كاميلا شعرت بضيقٍ في صدرها، متيقنةً كبزوغ الشمس أن النهر يتذكّر كل ذنب. وعندما تحطُّ الليالي الرطبة فوق أي مدينة تقيم فيها، أحيانًا تصيبها قشعة برد، تسمع بكاءً بعيدًا ينساب على ريح جنوبية، وتعرف أن لا يورونا ما تزال تمشي فوق الماء، تبكي، تصطاد، وتذكّر الأحياء أن الحب والفقد يتشاركان نفس التيار المظلم.













