المقدمة
متربعًا بين جدران مختبر مهترئ منعزل على أطراف جنيف، تدفعه روح فيكتور فرانكنشتاين الشاب القلقة إلى ما وراء حدود العلم المقبول. مدفوعًا بليالي محمومة تحت ضوء الشموع المتذبذب وهمسات رعود جبال الألب البعيدة، يجمع شظايا من معرفة محرَّمة. كل مرطبان من العينات المحفوظة، وكل طرف مقطوع، وكل قوس كهربائي يفرقع يصبح ضربة فرشاة في لوحته الكبرى. يدون ملاحظات دقيقة في دفاتر مغلَّفة بالجلد، يرسم الهيئة البشرية بتفصيل بديع، لكن لا دفتر يقدر أن يثقل بحجم الطموح. تحت حماس تجاربه يلتف همس من الرهبة حول أفكاره، بينما يهزّ الرعد المصاريع وتنسلّ الرياح الباردة عبر شقوق الحجر. يشعر أن إضفاء الحياة على المادة الجامدة يحمل عبئًا لا ينبغي لأي نفس بشرية أن تحمله. ومع تعاظم رائحة المطهر داخل ورشته وصدَى اصطدام الأدوات، يجد فيكتور نفسه على عتبة ستُعيد تعريف الخلق ذاته. قبل أن يخفق قلب المخلوق لمرّةٍ أولى، تُزرَع بذور النصر والمأساة في ذهن صانعه. في كل شرارة ترقص على رأس الإبرة، يلمَح فيكتور وعد المجد الأبدي وطيف العواقب التي لا تُمحى — خيار سيرتد صداه بعيدًا وراء هذه الجدران الوحيدة.
نشأة الخلق
بدأ افتتان فيكتور بالحياة حين أهدته والدته مجلدًا في التشريح وهو في الثالثة عشرة من عمره. كل صفحة من الرسوم كانت تعذّب فضوله بسؤال عمّا يكمن وراء العظم الساكن والعضو الخامل. بعد سنوات، في جامعة إنغولشتات، صبّ هذا الهوس في أبحاث مُرْهقة. كان يتجوّل في غرف التشريح في جنح الليل، يجمع شظايا الجثث ويغمسها في سوائل الحفظ. على طول الممرات الخافتة وتحت الفوانيس المتقطِّرة، اختلطت الحدود بين الحياة والموت. في صباحات مضاءة بالشموع، رسم كل وِتْرٍ وكل وعاء بدقّة مهووسة، باحثًا عن معادلة الحيوية. وعندما أمسك أخيرًا بقوة الكهرباء الرعدية لإنعاش الطين واللحم، خفق قلبه متزامنًا مع دقات العاصفة في الخارج.
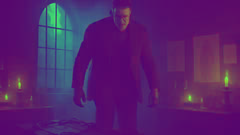
في القاعة الكبرى بجناحه الخاص رتّب فيكتور عمله تحت أقواس مقنطرة منحوتة بملائكة تبدو عيون حجرها كأنها تقوّم طموحه. وصل أوتارًا بأسلاك، وربط طرفًا بطرف، وأنابيب الدم بمضخات مرتجلة. حبس أنفاسه بينما رَنّت الأقطاب الكهربائية. تشقق برقٌ من القضبان المعدنية إلى قماش الجسد الجديد الشاحب. مع شرارة انبثاق الحياة تراجع فيكتور متعثرًا، وقلبه يلهث — مزيج من النشوة والرعب يحتدم في صدره. رفّت جفون المخلوق فانفتحت، كاشفة عن قزحيتين مرقشتين ببقع ذهبية تنبضان بحيرة خام.
لم يشعر بالانتصار أو بالارتياح، فتراجع فيكتور. كان أول شهيق خشن للمخلوق يرنّ في أذنيه كحكمٍ لا مفرّ منه. اجتاحته الخزي والرعب: لقد نسج الخلق من شظايا مسروقة وقوانين منتهَكة. في تلك المرافعة الصامتة، أدرك الخالق والمخلوق معًا أن لا شيء سيبقى بمنأى عن ثمن مثل هذا الفعل.
عزلة المخلوق
منبوذًا من خالقه ومطرودًا إلى برية مكسوة بالثلوج، ذاق المخلوق الوحدة لأول مرة بمرارة تفوق أي ريح شتوية. كان كل نفسٍ في الغابة المشقوقة بالجليد ينفث شبحًا من الحزن. تعثّر على أكواخ مهجورة حيث المواقد المترددة والضحكات الخافتة تذكّره بدفء قد لا يناله أبدًا. في الجداول المتجمدة حدّق في انعكاسه — تجميع لأجزاء غير متطابقة مؤطَّرة بعيون حزينة. محاولًا أن يسمي طبيعته، نهب المخلوق آثار المسافرين، جامعًا خِرَق الملابس وقطع الخبز.

مع امتداد الأيام إلى أسابيع، راقب الأسر البشرية من بعيد، مستقيًا لغة الشفقة. تعلّم اللطف في التهويدات الهمسية التي تنساب على نسمات الصيف، واكتشف الوجع في ترانيم الحزن التي تُنشد على قبور موحشة. في كل درس، سبق عقل المخلوق قلبه: فهم الحب لكنه ظل محرومًا من حضنه. وبازدياد بلاغته، زار القاعات الخالية وابتلع الكتب المتروكة — «الفردوس المفقود»، و«حيوات بلوتارخ» — كل نص حفَر أعماقًا جديدة من الشوق في روحٍ لم تعتنِ بها أي عائلة.
اشتدّ الصراع بين الجوع وكسر القلب في ذهن المخلوق: كانت رغبة في الانتقام تلوح كلما طعن الرفض جروحه من جديد. ومع ذلك، سيطر عليه التعاطف حين تذكّر لطفًا صغيرًا من شيخ أعمى قدم له ذات مرة قطعة خبز. ممزقًا بين العزلة المؤلمة وذكرى النعمة البشرية المتلألئة، عاهد المخلوق أن يواجه خالقه. وفي ذلك العهد كان الخيط الهش الذي يعيده إلى فيكتور — لقاء سيحلّ كل أوهام السيطرة ويطالب بحساب لا مفرّ منه لكليهما.
عواقب الخلق
عاد فيكتور إلى جنيف رجلاً أَجْوَف، وقد تآكلت آماله بوعد المخلوق: «سأكون معك ليلة زفافك.» صار يرى كل وجه ودود كقاضٍ، وكل احتفال كتهكّمٍ في وجهه. كانت أجراس الزفاف تملؤه رعبًا؛ وكل نذر مقدس بدا له كعدٍّ تنازلي إلى المجزرة. عشية زواجه من إليزابيث راقب الظلال وهي تلتف تحت أقواس الكاتدرائية الحجرية، وضاعت صلواته في صدى القِبَب المدوّية.

حين كثُفت الليلة بالرعد، اندفع فيكتور عبر شوارع مضاءة بالقمر نحو المصلى. بدا له داخل المصلى أن عروسه — إليزابيث — ممددة بلا حياة على المذبح، وعيونها المخيطة تحدق باتهامٍ نهائي. فُرض الرعب على صدره حين خرج المخلوق من الظلمة، ومعطفه الحريري مبتلّ بالمطر. في تلك الممرات الجوفاء ارتفعت كلمات اللوم واليأس في الليل حتى عجزت الألسنة عن نطق أي غفران.
مطاردًا بحزنِه، تعقّب فيكتور المخلوق عبر بحار جليدية وكتل من الجليد المتكسّر إلى صحارى القطب الشمالي. هناك، على سفينة محاصرة في صمت متجمد، انهار بجانب خليقه المهزوم — كلاهما مدفوع بالتمرّد، وكلاهما أهلكه الندم. في لحظاته الأخيرة أدرك العالم أن السعي إلى القوة من دون تواضع لا يولد سوى الخراب. ومع أنفاسٍ تضعف وبَرْدٍ على رموشه، فهم فيكتور أن المسؤولية الكبرى ليست في الشرارة التي تشعل الحياة، بل في الاختيار بأن نكرّم الأرواح التي نخلقها. وهمسًا بكلماتٍ من الغفران، ورّث إرثه للكائن ذاته الذي خلّقه، مختتمًا الفصل الوحيد الذي تعانق فيه الأمل والرعب.
الخاتمة
في وهج فجر القطب القاسٍ، كشفت الوصية الأخيرة لفيكتور فرانكنشتاين عن حقيقة عميقة: المعرفة المنزوعة عن الرحمة تحوّل المعجزات إلى مآسي. المخلوق، المصنوع من شرارة الطموح والمتروك في عزلة، حمل عبءَ كلٍ من الخالق والمخلوق معًا. وقف على حافة العالم، أنفاسه الممزقة تنجرف في هواء معبَّأ بالصقيع، مربوطًا بفهم لا يستطيع عقل بشري أن يمنحه لآخر: أن إحضار الحياة إلى الوجود يعني قبول الوصاية الأبدية على مصيرها. في ذلك الامتداد الصامت افترق الأب والابن الناتجان عن تجربة محرّمة بلا مصالحة، لكنهما شاركا حملًا واحدًا: ذاكرة الأعمال الرعدية، وحسرة الشغف الإنساني، وفعل لا رجعة فيه سيطارد كلاهما ما دامت الذاكرة باقية. إرث فرانكنشتاين لا يكمن فقط في شرارة الحياة، بل في الصدى الأخلاقي الذي يبقى بعد كل عاصفة — سائلاً دومًا ماذا يعني أن نخلق، ومن الذي يجب أن يتحمّل الثمن.













